بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت قبل يومين موضوع مفيد أعجبني كثيرا
عبارة عن تلخيص لالبوم رائع
أحببت ان تشاركوني قراءته فالبرغم من طول الموضوع الا انه يستحق القراءة
انصحكم بان تحفظوه وتقرأوه في اوقات الفراغ

___________________________
الحياة الطيبة البوم من ستة أشرطة لفضيلة الدكتور / عبد الكريم بكار ( حفظه الله تعالى )..
تناول أ. د . بكار في هذا الإصدار على نحو مفصل وعميق كثيراً من المعاني
التي تتصل بمفهوم السعادة والحياة الطيبة ، كما أنه تعرض على نحو شامل للأشياء
والأمور التي تنغص على الناس حياتهم من نحو ضياع الهدف الأسمى في الحياة
ونحو السأم والملل والحسد والكبر والغرور والشعور بالاضطهاد والفراغ والبطالة
والإرهاق والقلق والخوف والأنانية وما شاكل ذلك ..
كما أنه تحدث في محور ثالث عن الأمور التي تجلب للإنسان الهناء منطلقاً
من رؤية إسلامية أصيلة لطبيعة النفس البشرية وطبيعة أحداث الحياة التي تمر بها .
وقد تحدث في ذا السياق عن الإيمان بالله تعالى ومقتضياته ودوره في جلب الطمأنينة والسعادة ،
كما تحدث عن الاعتدال والتوسط والقناعة والرضا والعمل اليدوي والتبسم والبشاشة
والرؤية الكلية والعلاقات الاجتماعية وغير ذلك ..
وإننا إذ نقدم هذا العمل لنشعر بالثقة بأنه سوف يساعد على دفع الكثير من أسباب الشقاء ،
كما يساعد على جلب الكثير من أشكال السرور ...
والله الموفق .....
" الناشر "
الشريط الأول ....
بسم الله الرحمن الرحيم ..
الحمد لله رب العالمين .. حمد الشاكرين .. والصلاة والسلام على نبي الرحمة وإمام الهدى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين .. وبعد
فإن الله جل وعلا ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل إنقاذ البشرية من الشقاء ودفعها في اتجاه الحياة الكريمة الهانئة المطمئنة التي تليق بهذا الإنسان المكرم والذي سخر الله له ما في السموات والأرض منةً منه وفضلا .. هذه الحياة ليست هي الحياة الدنيا فحسب وليست هي الحياة الآخرة وحدها .. فالرؤية الإسلامية للدارين تقوم على أنهما يشكلان فصلين من رواية واحدة ومع أن الفصل الأول هو الأقصر وهو الأقل شأناً إلا أنه لا يقرأ الفصل الثاني ولا يفهم ولا يكون إلا بعد قراءته حيث لا حظ في الآخرة ولا في الجنة لمن لم يمر على الحياة الدنيا وهذا يشكل التفاتة مهمة إلى ضرورة عدم الاستخفاف بالحياة التي نحياها هنا على هذه الأرض حيث إنها تستحق منا كل الاهتمام وكل العناية ما دامت تشكل الممر الوحيد إلى الحياة الأبدية الخالدة والدائمة
ومع أن الله جل وعلا حذرنا من أن ننظر نظرة خاطئة أو نظرة جاهلة أو حولاء للدنيا ومتعها وملذاتها ومشكلاتها ومصائبها فإنه وعد عباده الصالحين بحياة طيبة على هذه الأرض تشكل هذه الحياة عاجل البشرى ومقدمة الجزاء الذي أعده لهم في الآخرة حيث قال جل وعلا ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) وهذه الحياة الطيبة الموعودة على الإيمان والعمل الصالح اختلف فيها المفسرون ، فقال بعضهم : إنها القناعة ، وقال آخر : إنها السعادة ، وهذا ما أرجحه ، وقيل هي حلاوة الطاعة ، وقيل : هي الاستغناء عن الناس والافتقار إلى الله تعالى ، وقيل : هي التوفيق إلى الطاعة التي تؤدي بالمؤمن إلى رضوان الله تعالى ،،،
واضح جدا أيها الإخوة الربط في هذه الآية بين إكرام الله لعباده الصالحين في الدنيا وبين إكرامه لهم في الآخرة حين يوفيهم أجورهم يوم ذاك بأحسن ما كانوا يعملون ، وقال سبحانه : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ) فالثياب الجميلة الحسنة والمطاعم اللذيذة مما أبيح للمسلم إذا خلا الاستمتاع بها من التبذير والكبر والخيلاء وهذه الأمور مشتركة في الدنيا بين جميع الناس برهم وفاجرهم ، مسلمهم وكافرهم ، لكنها في الآخرة تكون خالصة للمؤمنين وخاصة بمن فاز بمغفرة الله ورضوانه ،،،،
إن الله جلا وعلا قد فطر النفوس على الميل إلى النعيم وإلى الأمن والاطمئنان والرفاهية كما فطرهم على حب التقليل من بذل الجهد والبعد عما يسبب العناء والبعد عما يسبب الألم وكل ما يعكر المزاج ويهدد الاستقرار ، والأشخاص الذين يحبون أن يكونوا أشقياء تعساء غير موجودين ، أو هم في الحقيقة نادرون جداً أو هم مرضى ، وهناك يقين بأن المستمع الكريم يحب بشغف ولهفة أن يكون هانئاً في حياته ظافراً براحة البال ومستحوذا على الكثير من الطيبات ، ولا أدري على وجه اليقين إن كنت من خلال هذا العمل أستطيع أن أساعد نفسي وأن أساعده على بلوغ ذلك ، أرجوا منه ،،،،
ولا أذكر أنني عالجت موضوعا في يوم من الأيام فيه من الغموض والالتباس والتداخل والتشابك والاستثناءات ما وجدته في هذا الموضوع ، وسيلمس السامع الكريم ذلك من خلال تناولنا لهذه القضية الحيوية جدا بالنسبة إلى كل واحد منا ، وهذه في الحقيقة سميتها قضية تجوزاً ، هي ليست قضية ، إنها أم كل القضايا ، وليست مسألة لكنها أم كل المسائل ، ومشكلة كل المشكلات ،،،،
إن عقولنا وأمزجتنا مختلفة وإن وقع مسرات الحياة في نفوسنا يختلف من شخص إلى شخص آخر كما أن وقع كرباتها وآلامها وأحزانها في نفوسنا يختلف كذلك ، لهذا فإن كل واحد من يحتاج كي يحيا حياة طيبة إلى وصفة خاصة كما يحتاج المريض الذي يعاني من عدد من الأمراض الخطيرة إلى خطة علاجية دقيقة وشخصية وخاصة ، ولكن مع هذا فإن بين الناس العديد من الأمور المشتركة فنحن البشر محكومون بسنن إلهية واحدة وموحدة ، ولنا نزعات وميول متقاربة ، والأشياء التي تزعجنا كثيرة ومتنوعة ، لكن مع كثرتها ومع تنوعها هي مزعجات بالنسبة إلى كل واحد أو إلى معظم الناس ،،،
ومن هنا فإننا سننتفع بإذن الله تعالى من وراء زيادة بصيرتنا بما نريده من هذه الحياة وبما لا نريده ، كما سننتفع بالخبرات التي تعلمنا كيف نوجه إدراكنا وكيف نعيد تقييم الأشياء والأحداث من أفق عقائدنا ومن أفق الحاجات والشروط التي يمليها عيشنا في زمان كثير المغريات كثير المتطلبات زمان كثير الأزمات وكثير الفرص أيضا والتحديات ، علينا أن نكون صرحاء وواقعيين حتى لا نقع في التهويل أو التبسيط ،،،،
إن مفهوم السعادة " الحياة الطيبة " مفهوم غامض يكاد يكون سرا أودعه الله جلا وعلا في العلاقة القائمة بين الإنسان والأشياء ، فالإنسان الكائن المحدود مهما كان نافذ البصيرة ومهما ملك من المفاهيم والأدوات يظل عاجزاً عن إدراك ما يريده في هذه الحياة على وجه التحديد ، حيث إن كل واحد من مشتهياتنا قد يجلب لنا السرور والهناء لمدة ثم يفقد مفعوله وبهجته أو يتحول إلى شيء منغص نتمنى أننا لم نحصل عليه ،،،
سعادتنا الحقيقية تحتاج إلى علم مطلق بكل الأشياء وهذا ما لا سبيل إليه بالنسبة إلى كل واحد من البشر ولهذا فإن إتباع سبيل الله والامتثال لأمره والبحث عن مراضيه في المنشط والمكره والسراء والضراء إن ها يضمن لنا الكثير الكثير من أسباب الهناء والاطمئنان والفوز ، إنه يرسم لنا كل الخطوط العريضة ، وعلينا نحن باجتهادنا وبحنكتنا أن نبحث في التفاصيل و نتلمس ما يساعدنا على أن نكون أكثر اطمئناناً وأقل تعاسةً وشقاء
إن ظفرنا بالحياة الطيبة لا يحتاج إلى الكثير من العلم ، ولا يحتاج إلى الكثير من القواعد ، إذ لو أن العلم ينفع في هذا الباب لكان ما كتب عن أسباب السعادة والهناء كافياً لئلا يظل على وجه الأرض شقي واحد ولا تعيس ، إن حاجتنا الأساسية في إصلاح حياتنا الشخصية تتركز في الحكمة ، أي في نوعية القرار الذي يتخذه كل واحد منا ، وفي نوعية الاختيار للطريق الذي عليه أن يسلكه ، إن القليل من الحكمة ينفع المرء ولو لم يتوفر له إلا القليل من العلم لكن الكثير من العلم مع الحرمان من الحكمة قد لا يفيدنا إلا قليلا ، وقد لا نجد فيه أي شيء لإسعادنا ، ولهذا فهناك ما لا يحصى من العلماء التعساء ، وهناك ما لا يحصى من الحكماء السعداء ، وصدق الله تعالى إذ يقول : ( ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ) فلنطالع في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولنطلع على تراث الأمم ووصاياها وأمثالها وحكمها كي ننير بصائرنا وكي نتعرف على الطريق التي تؤدي فعلا إلى الحياة الطيبة هنا في الحياة الدنيا وهناك في الحياة الآخرة ، الحياة الطيبة قد تلتبس باللذة والنشوة ، وقد تلتبس بالشعور بالرضا عن الذات وعن الأوضاع المعيشية الراهنة ، ولهذا فلابد من محاولة الفصل بينها قبل أ نمضي في حديثنا إلى منتاه ،،،
لابد أيها الإخوان من القول : إن الله جل وعلا يسير الكون وفق نظم وقوانين كما أنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ووضع في الإنسان ميولاً فطرية غريزية تلح عليه كي يرضيها وذالك من أجل بقاء الإنسان ومن أجل استمراره في هذه الحياة لكنه في الوقت نفسه سنّ لنا الشرائع التي تتطلب منا تلبية حاجاتنا وإشباع غرائزنا وفق ما يعود علينا بالنفع الشامل وفي الإطار الآمن ، والناس في الامتثال لأمر الله أثناء تلبية حاجاتهم المختلفة هم في الحقيقة أجناس وأشكال ، وأسوأهم حالاً أولئك الذين يبحثون عن النشوة واللذة أينما كانت ومهما ترتب على الحصول عليها من مآثم وأضرار خاصة وعامة ، إنهم أرقاء لدى نزواتهم التي لا تعرف الارتواء ولا تتوقف عند أي حد اللهم إلا حداً واحدا هو حد العجز وحد الشيخوخة والأمراض الفتاكة ،،،،
ولنضرب مثالاً على ما نريد ، تناولنا للطعام يشكل ضرورة لبقائنا أحياءً ونحن حين نأكل نتلذذ بأكل ما نشتهيه ونصل في لحظة ما إلى حد الشبع وتلاشي الشهية ثم تتجدد الشهية مرة أخرى ونجد لذة جديدة عند تناول ما نشتهي ، إننا نشعر باللذة ما دام الطعام في أفواهنا فإذا تجاوزها ذهبت لذة تناول الطعام ، ومن هنا فإن اللذة تأخذ طابع المؤقت وتأخذ طابع العارض حيث لا يمكن إطالة أمدها والإحساس بها عن وقت تناولها ، ،،
وهذا شيء أساسي في تفريق اللذة عن السعادة ، الملذات ينقضي الإحساس بها مع انقضاء وقتها تماماً ثم تصبح شيئاً في الذاكرة ، وهذا الذي يشتهي الطعام بقوة إذا أكل عن الحد المعتاد فإن لذة تناول الطعام تكون سبباً في إصابته بالأمراض والأدواء ، وإذا تناول الإنسان ما هو ضار ببدنه فإنه أيضاً يشعر أنه في سبيل الشعور باللذة يلحق بنفسه وبجسده الأضرار والآلام ، ولهذا فإنه وهو يتلذذ بتناول الطعام لا يكون سعيداً على نحو خالص لأن صوتاً من داخله يحثه على الكف عن الطعام ، والعاقل يدرك أن هذه اللذة العابرة قد تخلف له من الأوجاع والأسقام الدائمة ما لا يتحمله بدنه ولاسيما عندما يتقدم به العمر ، ،،،
وهكذا ، فليست كل لذة سعادة ، مع أن السعادة والحياة الطيبة ترتبطان باللذة لكن ليست كل سعادة متوقفة على اللذة ، كما أنه ليست كل لذة سعادة ، حين نضع صدقة في يد فقير ونسمع منه دعوة صادقة فإننا لا نشعر بلذة لكننا نشعر بسعادة غامرة تصل في بعض الأحيان إلى أن تسيل دموعنا من الفرح بالعمل الذي قمنا به ، وكثيراً ما يتناقش أفراد الأسرة أثناء تناول الطعام وقد يشعرون بسعادة الحوار ومقارعة الحجة بالحجة أكثر من شعورهم بلذة الطعام ، إلى درجة نسيان أنهم يأكلون ، وقد يتطور الحوار إلى شجار فيغلب طابع النكد على الحضور وينسون مرة أخرى أنهم يأكلون ،،،
إذا كانت اللذة تأخذ طابع العابر والمؤقت وتخضع لغريزة الإرواء المباشر فإن الحياة الطيبة ليست كذلك ، إنها تشبه وضعية من يتربع على قمة من الانشراح والحبور والطمأنينة ورجاء ما عند الله من الخير ، إن من يحيا حياة طيبة يتلذذ بكل شيء في إيطار المباح وفي إيطار الاعتدال ، إنه لا ينساق خلف لذة عابرة متجاهلاً الآثار السيئة والأضرار البالغة التي تترتب عليها في الدنيا أو في الآخرة ، إنه يتصرف في الحاضر مراعياً المستقبل عن طريق تنظيم تناوله للملذات وإيقاف رغباته عند الحدود التي يتطلبها الاستمرار في السعادة والاستمرار في الطمأنينة ،،،
من شأن طالب الملذات أن يرتمي على كل لذة تعرض ليعب منها على مقدار ما يستطيع ، أما طالب الحياة الطيبة ، فإنه يريد للذته أن تكون شاملة ، تتصل بوجوده كله ، وترعى حاجاته وميوله وقيمه وأخلاقه وتراعي قيم المجتمع الذي يعيش في وما يتصل بمصيره ومستقبله ،،،
حين ينظم الإنسان طريقة تلذذه بالحياة لتكون على الوصف والوضع الذي أشرت إليه ، فإنه بعون الله وتوفيقه يتمكن من تحويل السرور إلى فرح والإحساس إلى ابتهاج والمتعة إلى حبور ،إنه يشعر أنه على الطريق الصحيح ، وفي الوضعية الصحيحة ، ويشعر أنه ليس أقل من غيره ، وان ما يتوقعه من رحمة الله ولطفه ومعونته سيجعل ما هو قادم من الأيام أفضل وأجمل وأمتع مما هو حاضر ،،،
إن بين اللذة والحياة الطيبة فارقاً أشبه بالفارق بين الإنفاق الفوري لمالٍ جاهز يمتلكه وبين تكوين رأس مال أو احتياط للأيام القادمة ،،،
إذا تركنا نفوسنا دون مجاهدة أو استخدام للعقل والذكاء والتدبير فإنها ستندفع إلى البحث عن الملذات كما يندفع الماء نحو الأماكن المنخفضة ، وهذا هو شأن البهائم ، لكن الله جل وعلا لم يكلف البهائم بشيء ولم يعدها بجنان الخلد ولا أعطاها العقل ولا فإنه سبحانه وفر لها الاعتدال ووفر لها الحماية عن طريق الغريزة ، فالحيوان لا يصاب بالتخمة كما يصاب الإنسان ولا يصطاد إلا على مقدار حاجته ، أما الإنسان فإنه مستعد لأن يوقع في الأزمات وفي المآسي ألوفاً من البشر في سبيل إرضاء نزواته ، لذالك هنا نقول فلان صاحب شهوة بهيمية ، ربما تكون هذه العبارة تنطوي على شيء من الظلم للبهائم ، الشهوة الإنسانية حينما تنطلق في أي مجال دون اعتبار أخلاقي أو دون اعتبار ديني أواعتبار إنساني يعني حينما تنطلق تفوق شهوات البهائم بمراحل في الحقيقة ،،،
إن عقولنا وأمزجتنا مختلفة وإن وقع مسرات الحياة في نفوسنا يختلف من شخص إلى شخص آخر كما أن وقع كرباتها وآلامها وأحزانها في نفوسنا يختلف كذلك ، لهذا فإن كل واحد من يحتاج كي يحيا حياة طيبة إلى وصفة خاصة كما يحتاج المريض الذي يعاني من عدد من الأمراض الخطيرة إلى خطة علاجية دقيقة وشخصية وخاصة ، ولكن مع هذا فإن بين الناس العديد من الأمور المشتركة فنحن البشر محكومون بسنن إلهية واحدة وموحدة ، ولنا نزعات وميول متقاربة ، والأشياء التي تزعجنا كثيرة ومتنوعة ، لكن مع كثرتها ومع تنوعها هي مزعجات بالنسبة إلى كل واحد أو إلى معظم الناس ،،،
ومن هنا فإننا سننتفع بإذن الله تعالى من وراء زيادة بصيرتنا بما نريده من هذه الحياة وبما لا نريده ، كما سننتفع بالخبرات التي تعلمنا كيف نوجه إدراكنا وكيف نعيد تقييم الأشياء والأحداث من أفق عقائدنا ومن أفق الحاجات والشروط التي يمليها عيشنا في زمان كثير المغريات كثير المتطلبات زمان كثير الأزمات وكثير الفرص أيضا والتحديات ، علينا أن نكون صرحاء وواقعيين حتى لا نقع في التهويل أو التبسيط ،،،،
إن مفهوم السعادة " الحياة الطيبة " مفهوم غامض يكاد يكون سرا أودعه الله جلا وعلا في العلاقة القائمة بين الإنسان والأشياء ، فالإنسان الكائن المحدود مهما كان نافذ البصيرة ومهما ملك من المفاهيم والأدوات يظل عاجزاً عن إدراك ما يريده في هذه الحياة على وجه التحديد ، حيث إن كل واحد من مشتهياتنا قد يجلب لنا السرور والهناء لمدة ثم يفقد مفعوله وبهجته أو يتحول إلى شيء منغص نتمنى أننا لم نحصل عليه ،،،
سعادتنا الحقيقية تحتاج إلى علم مطلق بكل الأشياء وهذا ما لا سبيل إليه بالنسبة إلى كل واحد من البشر ولهذا فإن إتباع سبيل الله والامتثال لأمره والبحث عن مراضيه في المنشط والمكره والسراء والضراء إن ها يضمن لنا الكثير الكثير من أسباب الهناء والاطمئنان والفوز ، إنه يرسم لنا كل الخطوط العريضة ، وعلينا نحن باجتهادنا وبحنكتنا أن نبحث في التفاصيل و نتلمس ما يساعدنا على أن نكون أكثر اطمئناناً وأقل تعاسةً وشقاء
إن ظفرنا بالحياة الطيبة لا يحتاج إلى الكثير من العلم ، ولا يحتاج إلى الكثير من القواعد ، إذ لو أن العلم ينفع في هذا الباب لكان ما كتب عن أسباب السعادة والهناء كافياً لئلا يظل على وجه الأرض شقي واحد ولا تعيس ، إن حاجتنا الأساسية في إصلاح حياتنا الشخصية تتركز في الحكمة ، أي في نوعية القرار الذي يتخذه كل واحد منا ، وفي نوعية الاختيار للطريق الذي عليه أن يسلكه ، إن القليل من الحكمة ينفع المرء ولو لم يتوفر له إلا القليل من العلم لكن الكثير من العلم مع الحرمان من الحكمة قد لا يفيدنا إلا قليلا ، وقد لا نجد فيه أي شيء لإسعادنا ، ولهذا فهناك ما لا يحصى من العلماء التعساء ، وهناك ما لا يحصى من الحكماء السعداء ، وصدق الله تعالى إذ يقول : ( ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ) فلنطالع في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولنطلع على تراث الأمم ووصاياها وأمثالها وحكمها كي ننير بصائرنا وكي نتعرف على الطريق التي تؤدي فعلا إلى الحياة الطيبة هنا في الحياة الدنيا وهناك في الحياة الآخرة ، الحياة الطيبة قد تلتبس باللذة والنشوة ، وقد تلتبس بالشعور بالرضا عن الذات وعن الأوضاع المعيشية الراهنة ، ولهذا فلابد من محاولة الفصل بينها قبل أ نمضي في حديثنا إلى منتاه ،،،
لابد أيها الإخوان من القول : إن الله جل وعلا يسير الكون وفق نظم وقوانين كما أنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ووضع في الإنسان ميولاً فطرية غريزية تلح عليه كي يرضيها وذالك من أجل بقاء الإنسان ومن أجل استمراره في هذه الحياة لكنه في الوقت نفسه سنّ لنا الشرائع التي تتطلب منا تلبية حاجاتنا وإشباع غرائزنا وفق ما يعود علينا بالنفع الشامل وفي الإطار الآمن ، والناس في الامتثال لأمر الله أثناء تلبية حاجاتهم المختلفة هم في الحقيقة أجناس وأشكال ، وأسوأهم حالاً أولئك الذين يبحثون عن النشوة واللذة أينما كانت ومهما ترتب على الحصول عليها من مآثم وأضرار خاصة وعامة ، إنهم أرقاء لدى نزواتهم التي لا تعرف الارتواء ولا تتوقف عند أي حد اللهم إلا حداً واحدا هو حد العجز وحد الشيخوخة والأمراض الفتاكة ،،،،
ولنضرب مثالاً على ما نريد ، تناولنا للطعام يشكل ضرورة لبقائنا أحياءً ونحن حين نأكل نتلذذ بأكل ما نشتهيه ونصل في لحظة ما إلى حد الشبع وتلاشي الشهية ثم تتجدد الشهية مرة أخرى ونجد لذة جديدة عند تناول ما نشتهي ، إننا نشعر باللذة ما دام الطعام في أفواهنا فإذا تجاوزها ذهبت لذة تناول الطعام ، ومن هنا فإن اللذة تأخذ طابع المؤقت وتأخذ طابع العارض حيث لا يمكن إطالة أمدها والإحساس بها عن وقت تناولها ، ،،
وهذا شيء أساسي في تفريق اللذة عن السعادة ، الملذات ينقضي الإحساس بها مع انقضاء وقتها تماماً ثم تصبح شيئاً في الذاكرة ، وهذا الذي يشتهي الطعام بقوة إذا أكل عن الحد المعتاد فإن لذة تناول الطعام تكون سبباً في إصابته بالأمراض والأدواء ، وإذا تناول الإنسان ما هو ضار ببدنه فإنه أيضاً يشعر أنه في سبيل الشعور باللذة يلحق بنفسه وبجسده الأضرار والآلام ، ولهذا فإنه وهو يتلذذ بتناول الطعام لا يكون سعيداً على نحو خالص لأن صوتاً من داخله يحثه على الكف عن الطعام ، والعاقل يدرك أن هذه اللذة العابرة قد تخلف له من الأوجاع والأسقام الدائمة ما لا يتحمله بدنه ولاسيما عندما يتقدم به العمر ، ،،،
وهكذا ، فليست كل لذة سعادة ، مع أن السعادة والحياة الطيبة ترتبطان باللذة لكن ليست كل سعادة متوقفة على اللذة ، كما أنه ليست كل لذة سعادة ، حين نضع صدقة في يد فقير ونسمع منه دعوة صادقة فإننا لا نشعر بلذة لكننا نشعر بسعادة غامرة تصل في بعض الأحيان إلى أن تسيل دموعنا من الفرح بالعمل الذي قمنا به ، وكثيراً ما يتناقش أفراد الأسرة أثناء تناول الطعام وقد يشعرون بسعادة الحوار ومقارعة الحجة بالحجة أكثر من شعورهم بلذة الطعام ، إلى درجة نسيان أنهم يأكلون ، وقد يتطور الحوار إلى شجار فيغلب طابع النكد على الحضور وينسون مرة أخرى أنهم يأكلون ،،،
إذا كانت اللذة تأخذ طابع العابر والمؤقت وتخضع لغريزة الإرواء المباشر فإن الحياة الطيبة ليست كذلك ، إنها تشبه وضعية من يتربع على قمة من الانشراح والحبور والطمأنينة ورجاء ما عند الله من الخير ، إن من يحيا حياة طيبة يتلذذ بكل شيء في إيطار المباح وفي إيطار الاعتدال ، إنه لا ينساق خلف لذة عابرة متجاهلاً الآثار السيئة والأضرار البالغة التي تترتب عليها في الدنيا أو في الآخرة ، إنه يتصرف في الحاضر مراعياً المستقبل عن طريق تنظيم تناوله للملذات وإيقاف رغباته عند الحدود التي يتطلبها الاستمرار في السعادة والاستمرار في الطمأنينة ،،،
من شأن طالب الملذات أن يرتمي على كل لذة تعرض ليعب منها على مقدار ما يستطيع ، أما طالب الحياة الطيبة ، فإنه يريد للذته أن تكون شاملة ، تتصل بوجوده كله ، وترعى حاجاته وميوله وقيمه وأخلاقه وتراعي قيم المجتمع الذي يعيش في وما يتصل بمصيره ومستقبله ،،،
حين ينظم الإنسان طريقة تلذذه بالحياة لتكون على الوصف والوضع الذي أشرت إليه ، فإنه بعون الله وتوفيقه يتمكن من تحويل السرور إلى فرح والإحساس إلى ابتهاج والمتعة إلى حبور ،إنه يشعر أنه على الطريق الصحيح ، وفي الوضعية الصحيحة ، ويشعر أنه ليس أقل من غيره ، وان ما يتوقعه من رحمة الله ولطفه ومعونته سيجعل ما هو قادم من الأيام أفضل وأجمل وأمتع مما هو حاضر ،،،
إن بين اللذة والحياة الطيبة فارقاً أشبه بالفارق بين الإنفاق الفوري لمالٍ جاهز يمتلكه وبين تكوين رأس مال أو احتياط للأيام القادمة ،،،
إذا تركنا نفوسنا دون مجاهدة أو استخدام للعقل والذكاء والتدبير فإنها ستندفع إلى البحث عن الملذات كما يندفع الماء نحو الأماكن المنخفضة ، وهذا هو شأن البهائم ، لكن الله جل وعلا لم يكلف البهائم بشيء ولم يعدها بجنان الخلد ولا أعطاها العقل ولا فإنه سبحانه وفر لها الاعتدال ووفر لها الحماية عن طريق الغريزة ، فالحيوان لا يصاب بالتخمة كما يصاب الإنسان ولا يصطاد إلا على مقدار حاجته ، أما الإنسان فإنه مستعد لأن يوقع في الأزمات وفي المآسي ألوفاً من البشر في سبيل إرضاء نزواته ، لذالك هنا نقول فلان صاحب شهوة بهيمية ، ربما تكون هذه العبارة تنطوي على شيء من الظلم للبهائم ، الشهوة الإنسانية حينما تنطلق في أي مجال دون اعتبار أخلاقي أو دون اعتبار ديني أواعتبار إنساني يعني حينما تنطلق تفوق شهوات البهائم بمراحل في الحقيقة ،،،
" الشعور بالرضا"
نحن قلنا نفرق بين الحياة الطيبة أو الشعور بالسعادة وبين الشعور باللذة وبين الشعور بالرضا ن الشعور بالرضا شيء غير السعادة وغير اللذة ، إنه شعور تنتجه المقارنة مع الآخرين والتي تفضي إلى الإحساس بالتفوق والكفاءة والنجاح ، حين تكون طبيباً ناجحاً وتتذكر بائع الخضار أو الحداد الذي كان معك في الصف الثالث الابتدائي وربما كان متفوقاً عليك آن ذاك فإنك لا محالة ستشعر بالرضا عن الإنجاز الذي حققته بالنسبة إلى ما حققه زميلك في الدراسة سابقا ، الشعور بالرضا عن الموقع الذي يحتله الواحد منا وعن العمل الذي يعمل فيه لا يخالط شغاف القلب ! لماذا ؟ لأنه عمل عقلي يقنع المرء من خلاله نفسه بأنه قوي وبأنه متفوق وبأنه كفء وهو في تصوري شعور عابر ويمكن أن يتحول إلى نعيم إذا قرناه بالحمد والشكر لله والثناء على ما هدى ووفق وأعان ، وحاولنا تأدية زكاة ذلك ،، فالتفوق على صورة مساعدة لمن يحتاج المساعدة من الأهل والأصدقاء والجار ،،،
ومع هذا فلنكن على حذر فإن الشعور بالرضا الذي تأتي به المقارنات تذهب به أيضاً المقارنات ، إذا نحن نظرنا إلى أحد الأقران السابقين فوجدناه أكثر منا ثراءً أو أكثر نجاحاً أو أكثر نفوذاً أو أكثر صلاحاً إذا وجدنا ذلك فإن الشعور بالرضا يذهب ليحل محله الشعور بالتعاسة ، ،،
خلاصة كل ما قلناه هنا وأحب أن أسوق هذه الخلاصة للتركيز على المعاني السابقة ...
الخلاصة : أن الله جل وعلا يحب لعباده أن ينجحوا في الاختبار والابتلاء الذي كتبه عليهم إ أوجدهم في هذه الدنيا كما أن سبحانه أرشدهم إلى كل ما يوفر لهم الحياة الطيبة السعيدة وترك لهم أن يختاروا ما يرونه مناسباً لهم ، وذكرنا أيضاً أن علينا أن لا نخطئ كما أخطأ الملحدون والعلمانيون وأولئك الغارقون في الشهوات حين نظروا إلى الدنيا على أنها هي الفرصة الوحيدة لاقتناص الملذات ، فاختلت حياتهم كلها وهدموا في أنفسهم وأبدانهم العديد من الجوانب دون أن يشعروا أو دون أن يكونوا قادرين على فعل ما يرونه يصب في مصلحتهم الحقيقية ، إن نظرتنا إلى الحياة الطيبة لن تكون أبداً صحيحة وصائبة إلا إذا نظرنا إلى الدنيا على أنها بكل ما فيها ليست سوى الفصل الأول من الرواية ، والحكم على أننا سعداء أو أشقياء من خلالها سيكون مثل حكم الذي حكم على الرواية دون أن يقرأ الفصل الأخير فيها ،،،
الحكمة هي التي نحتاجها في إدارة حياتنا وحين نحرم منها فإن العلم لن ينفعنا كثيرا في ترشيد اختياراتنا وقراراتنا ، وقد فرقنا كما مر بنا قبل قليل بين اللذة والنشوة بوصفهما أمرين سريعين عابرين وبين السعادة بوصفها الوضعية الجيدة والملائمة لمتطلبات قيمنا وعقائدنا وغرائزنا وحاجات مستقبلنا ، ومع أن السعادة تشتبه باللذة لكن كما ذكرت لا تتطابقان ولا يتوقف على نحو دائم حصول واحدة على وجود الأخرى ،،، هذا ملخص سريع لما ذكرته في الدقائق الماضية ،،،
ولعلي هنا أسوق بعض الرؤى والخبرات حول السعادة لعلماء ومفكرين وفلاسفة وخبراء مسلمين وغير مسلمين لعلنا نجد فيها ما يهدينا إلى بلورة رؤية أكثر وضوحاً حول هذه القضية المهمة والحية أو قضية القضايا كما أشرت ، ولعلنا أيضا نجد فيها ما يرشد سلوكنا واهتماماتنا في طلب الحياة الطيبة ،،،،
يقول أحدهم : إن السعادة الحقيقية تكمن في تقدير مواهب الآخرين والفرح لفرحهم ولهذا فإن أسعد إنسان هو ذاك الذي كلما رأى شخصاً مسروراً أحس بالسرور يتغلغل في نفسه ، وبما أن المسرورين في هذه الدنيا كثيرون فإنه سيجد دائماً مصدراً متجدداً لمباهج الروح ، طبعاً لم يسأل صاحب هذا القول نفسه عما إذا كان هذا المبتهج بسعادة الآخرين يعاني من مغص كلوي أو من تراكم الديون أو من قهر عدو ، كيف يمكن تجاوز ذالك بكل ضغوطاته إلى الإحساس بالآخرين ...
حكيم آخر نظر إلى الوجه الآخر من العملة حين قال : إن القلوب الكبيرة لا تسعد أبداً بسبب ما تحسه من نقص في سعادة الآخرين ، وعلى هذا فالسعادة من نصيب الأنانيين ومن نصيب المغفلين ، فهذا يؤكد ما ذكرته قبل قليل من أن قضية السعادة قضية ملتبسة وقضية غامضة تضطرب فيها الأقوال إلى حد التناقض والتضاد ،،،
السؤال الذي يطرح نفسه على هذا القول : كيف تكون حال أولئك الذين يحبون العزلة الاجتماعية فلا يشعرون بالسعداء ولا يشعرون بالأشقياء ؟ هل يكونون في منزلة بين المنزلتين ؟ كما تقول بعض الفرق في بعض المسائل !! أي لا مع الأشقياء ولا مع السعداء ؟؟؟؟!!!
لا ريب أن كل واحدٍ من هذين القولين ينطوي على شيء من المبالغة وينطوي أيضاً على جزء من الحقيقة ..
يقول ثالث : ضاعف جهلك لتبلغ السعادة . ويعني بذالك أن الذين يدققون في الأشياء ويطلعون على ما في الواقع يجدون الكثير من الخلل والكثير من الفواجع مما يكدر خاطرهم ، ولذا فإن جهلهم يحميهم من ذالك ، ولهذا القول نصيب من الصحة لكن علينا أن لا ننسى المتعة الكبيرة التي يجدها الإنسان في معرفة أسباب الأشياء والحوادث ومعرفة العلاقات التي تربط بينها ، ولذا فإن بعض الفلاسفة يرى أن السعادة الكبرى هي من نصيب من يحسن التأمل في أسرار الوجود ويعرف أكثر عن حكمة الخالق جل وعلا في خلقه ، ،،،
وقد ذكروا أنه قيل لأبي بكر الخوارزمي عند موته في ساعات الإحتظار أو في بداية الإحتظار قالوا له ما تشتهي : قال النظر في حواش الكتب ، وهو في وداع الدنيا يجد متعة معينة أو فائدة كبرى في أن يكون آخر ما يعمله في هذه الحياة هو أن يقرأ ويطلع ويعرف ،،،،،
هناك من يرى السعادة كامنة في رؤيتنا للأشياء وتفسيرنا للواقع وردود أفعالنا على الحوادث ويعلل لذلك بأن لكل شيء في حياتنا عشرين ظلاً ومعظم هذه الضلال من صنع الناس ، ويشير إلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام : ( عجباً لأمر المؤمن كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وليس ذالك لأحدٍ إلا للمؤمن ) فرؤيتنا للأشياء وعلاقتنا بها وتفسيرنا لها هي الأمور الحاسمة في تقرير كونها أموراً تجلب السعادة أو تجلب الشقاء ،،،،
هناك قول طريف في شأن السعادة حيث يرى صاحبه أن السعادة في الدنيا ليست سوى شبح يرجى فيطارد ويلاحق فإن وقع في القبضة وصار شيئاً متجسداً ملموساً مله الناس وسئموه وحاولوا البحث عن غيره وكأن سعادة الناس وفق هذا القول الحكيم تكمن في ملاحقتهم لما يظنونه مصدراً لإسعادهم وليس في التمتع به يعني متعة الرحلة أكبر من متعة محطة الوصول أو نهاية الرحلة أو هدف الرحلة في نظر هذا الحكيم وهذا القول مع أنه يلمس جانباً غير قليل وغير صغير من الموضوع لكنه لا يخلوا من شيء من التطرف لأن ما نصل إلي يغير في البيئة التي نعيش فيها ويحسن في ظروف العيش وليس كل شيء نصل إليه يصبح بعد مدة مملولا ...
بعض الحكماء يرى أن أسعد الناس هم أولئك الذين يكتشفون أم ما ينبغي أن يفعلوه وما يفعلونه في الواقع هما شيء واحد ، أي أن لديهم إحساساً بالتطابق التام بين سلوكياتهم ومواقفهم من جهة وبين معتقداتهم والقيم التي يؤمنون بها من جهة أخرى ، و لا ريب أن من يكون كذالك يظفر بشي قليل من السعادة إنه يطمئن إلى قدر كبير من خيرية ذاته وخيرية مصيره وكثير من النصوص يشير إلى هذا المعنى لكن علينا أن نعمق الفهم حتى لا ننساق خلف الأفكار الجميلة ،،،
إن المرء حتى يكتشف أنه يفعل كل ما ينبغي أن يفعل يحتاج إلى العصمة وهذه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وليست لعامة الناس ، ثم أن جزءً من أخطائنا يعود إلى اجتهادنا وحين يجتهد الواحد من ويخطئ فإن نتائج اجتهاده الخاطئ سوف تعكر حياته وتجعل سعادته منقصوه ثم ماذا يمكن أن يصنع الخيرون إذا كانت نظرتهم للحياة تميل إلى التشاؤم مثلاً ورؤية السلبيات عوضاً عن الإيجابيات لاشك ، أن ذالك يجلب لصاحبه التعاسة حيث لابد من نوع من الاعتقاد بخيرية العالم أي بوجود الخير لدى كثير من الناس ووجود إمكانية لتمكين ذالك الخير، إذا لم نشعر بهذا بخيرية العالم على الوجه الذي شرحته فإننا سنشعر بالتعاسة وانسداد الآفاق وانقطاع الحيلة ، وفي موروثنا الثقافي الكثير الكثير من المرويات عن أناس أخيار لكنهم أصحاب نظرة سوداوية سلبية.
الاستقامة على الشريعة مصدر من أعظم مصادر السعادة والطمأنينة ، ومن غير الاستقامة والشعور بحد كبير وبقدر كبير من التطابق بين المعتقد والسلوك بدون هذا لن يكون هناك مطمع بحياة طيبة لكن الاستقامة مع أهميتها ليست الشرط الوحيد ، فهناك شروط أخرى إلى جانبه ،،،
هناك من يقول أن الصحة هي الشيء الوحيد الذي يجعلك تشعر بأن اليوم الذي تعيشه الآن هو أفضل وقت في السنة ، ولا يخفى على عاقل ألا شعور بالسعادة مع وجود الأسقام والآلام ، لكن الذي ثبت أن المرء يتكيف مع البلوى شيئاً فشيئا ، والحقيقة لو كان الذين يتألمون ، يتألمون ويشعرون بالألم بالدرجة التي نظنها لا واجهوا صعوبات هائلة في الحياة لكن مع الأيام مع الأيام تصغر المصائب وتنخفض توقعات المرء ويتكيف مع المصائب والبلاوي التي يعيش فيها ، يمكن للمؤمن أن يبصر من خلال البلوى أيضاً رحمة الله تعالى ويبصر ثوابه فيخف تأثير ذالك البلاء فيه ، إن الصحة شيء لا نشعر به إلا إذا فقدناه ، ولذا فوجدودها شرط للسعادة..
لكن أيضا هناك شرط من شروط بعض فلاسفة اليونان مثل أرسطو كان يقول : السعادة تكمن في الحكمة ولا يوجد سعيد في العالم إلا العاقل وعلى هذا فالفلاسفة المفكرون الكبار الذين يشتغلون بالأعمال الفكرية ، المثقفون الكبار هم أسعد الناس في رأي أرسطو وهذا القول قريب من قول من يقول إن السعادة تكمن في العلم ومعرفة أسباب الأشياء ولكن واقع الحياة يؤكد أن عدداً كبيراً من العلماء انتحروا عدد كبير من العلماء كانوا دائماً يعبرون عن الحرمان الذي يعيشونه وعن أنهم أشقياء ، هذا واقع ولا تسطيع أن تقول لشخص يقول إنه شقي أن تقول له أنت مخطئ أنت سعيد هذا صعب ...
أختم بـقول واقعي وطريف وبعيد عن كل المعايير الموضوعية ، قول يعتمد على الميول الشخصية على الأحاسيس الشخصية وليس على المعايير التي يمكن تداولها بين الناس ، هذا القول يرى صاحبه ليست في المال أو الجاه وليست في الصحة وليست في الفضيلة وليست في الإيثار للآخرين على النفس ولا في أي شيء من هذه ، إنها في شيء واحد ، هذا الشيء هو ظن المرء بأنه سعيد إذا شعرت بأنك سعيد فأنت سعيد ولا تلتفت إن كنت تعيش في الصحراء ، عندك مكيف ليس عندك مكيف ، عندك عشاء ليس عندك عشاء ، عليك ديون لك ديون ، لا فرق ، المهم ما ذا تقول أنت !! فإذا قلت إنك سعيد فأنت سعيد ، ومن الحكمة ومن المصلحة إذا كنت تشعر بهذا أن لا تبحث أبداً عن أسباب سعادة لأنك لو بحثت ربما زال ذالك الشعور ، السعادة شعور بالانشراح والأمن والإقبال على الحياة والهناء فإذا ظن الواحد أنه يملك هذا الشعور فهو إذا كما قلت سعيد بقطع النظر عن كل ما قيل وكل ما يقال حول شروط السعادة وحول مقوماته وحول أسبابها وحول منغصاتها كل هذه ما لها قيمة أمام إقرار الإنسان أنه يتمتع بسعادة وارفة وبهناء كبير ، هذا القول جميل جداً الحقيقة ، وربما كان أرجح الأقوال إذ لا تستطيع أن تقول لشخص يقول عن نفسه أنه يشعر بالسعادة تقول له أنه غير سعيد مهما كان لديك من الأدلة والبراهين على أنه شقي وبائس ، وقد نجهد أنفسنا ونستعين بطبيب نفسي في إقناع شخص بأنه ليس تعيسا أيضا في المقابل قد نبذل كل جهد في إقناع شخص يشعر بأنه تعيس لنبرهن له على أنه ليس بتعيس نبذل كل الجهود ونستعين بمن نستعين بهم ولكن نجد أنفسنا في النهاية عند نقطة البداية وكأننا لم نفعل أي شيء ...
إن السعادة أيها الإخوة والأخوات تقوم في حقيقة الأمر على جملة من الحقائق وجملة من الأخيلة وجملة من الأوهام تركيبة منوعة و معقدة ، حقائق وأخيلة وأوهام ، فإذا توهم شخص بأنه سعيد فدعه في توهمه يشعر بالغبطة فذالك خير لك وخير له ...
الأقوال عن السعادة تذكرنا بقصة العميان الذين وضع كل واحد منهم يده على جزء من الفيل ظناً منه أن ذالك الجزء هو الفيل كله ، ثم شرع كل واحد يصف الفيل من منطلق ظنه ، فخرجوا بأوصاف كثيرة متباينة كما خرج أصحابنا عن الحديث عن السعادة ..
الأقوال التي سمعناها عن السعادة كلها صحيحة وكلها في الوقت نفسه خاطئة ، هي صحيحة إذا قلنا أنها تفسر بعض أسباب أو بعض مظاهر السعادة وهي خاطئة إذا قلنا أنها تفسر الظاهرة بشكل كامل ومشكلة قائلي تلك الأقوال تعميم تجاربهم ورؤاهم الشخصية على نحو ينفي تجارب غيرهم ومرئياتهم ..
.
بعد هذا دعونا نتناول ملاحظتين إضافيتين بعد التعريفات الطريفة واللطيفة للسعادة و للحياة الطيبة لعلنا نتمكن من الاقتراب من هذا اللغز الغامض والمحير أكثر فأكثر ..
* الملاحظة الأولى ...
تكمن في النصيحة التالية ...
لا تجعل السعادة هدفاً تسعى إليه ، وهذه النصيحة عجيبة وربما تلقاها كثير من الناس بالاستنكار وهم محقون في ذالك لأننا جميعاً في واقع الحال نطارد شيئاً نظن أن فيه ما هو أريح وأمتع وأنعم وأرفه ، لكن هل نحن مصيبون في ذالك أم أننا نبحر في محيط الوهم الأكبر حيث ننتقل من جزيرة إلى جزيرة ظانين أن الجزيرة التي نصل إليها هي الجزيرة المبتغاة ، حتى إذا ما حللنا فيها اكتشفنا أنها أقل مما نؤمل ونرتجي ، وبعد مدة يصيبنا السأم والملل فننشر الأشرعة ونبحر صوب جزيرة أخرى ..
تجربة كثير من أهل الفكر والحكمة والخبرة تقول لنا : إن خير وسيلة لبلوغ السعادة هي ألا تتخذ السعادة غرضاً مباشرا ، ولا هدفاً صريحا ، لأنك إذا فعلت ذالك صارت السعادة بالنسبة إليك مثل فريسة يخطئها الصياد كلما سدد نحوها من مكان بعيد ، إنك لو تأملت في حياة معظم الناس وربما كنت أنا وأنت منهم لوجدت أن القسم الأول من الحياة ينقضي في اشتهاء القسم الثاني وما يخبئ هذا القسم الثاني والأخير من مفاجآت سارة ، أما القسم الثاني فإنه ينقضي في التأسف على القسم الأول كما يتأسف الشيوخ على الشباب ، كما قال الشاعر :
ألا ليت الشباب يعود يوما *** فأخبره بما فعل المشيب
وكنت قد سمعت من طفلة في السادسة أو السابعة من عمرها ذات يوم ـ هذا الكلام كان قبل عشرين سنة ـ سمعت منها تلخيصاً مفيداً لهذا المعنى ، معنى انتظار القسم الثاني من الحياة والتأسف فيه على القسم الأول ، تلك الطفلة قالت هذه الحقيقة لكن بلغة أخرى حيث قالت : الأطفال الصغار يحاولون الظهور بمظهر من هو أكبر منهم ، أما الكبار فإنهم يحاولون الظهور بمظهر الكبار ، مشكلة السن والتقدم في السن عند الجميع قضية غير مرغوب فيها ولاسيما عند النساء ، هذا الكلام الذي قالته تلك الطفلة من عشرين سنة يتأكد اليوم في الحقيقة من خلال فنون عمليات التجميل التي يقوم بها الكبار من رجال ونساء لإصلاح ما أفسدته الأيام .
وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر
يقول أحد كبار الأدباء العرب في العصر الحديث : كيف السبيل إلى السعادة والرضا وأنا لم أبلغ شيئاً إلا تطلعت إلى شيء آخر أبعد منه منالا ولم أحقق أملا لنفسي أو للناس إلا اندفعت إلى أمل هو أشق منه وأصعب تحقيقا ؟؟؟؟؟
فإذا كان الأمل الذي لا حد له ، والعمل الذي لا راحة منه ، إذا كان هذا يعد في نظركم سعادة ، فأنا السعيد الموفور الحظ ، ما في ذالك شك ، أما إذا كانت السعادة هي الرضا الذي لا يشوبه سخط ، والراحة التي لا يشوبها تعب والنعيم الذي لا يعرض له بؤس فإني لم أذق هذه السعادة بعد ، ما أرى أني سأذوقها إلا أن يأذن الله لي فيما بعد هذه الحياة بشيء منها ،،
تمنى أحدهم أن لو كان الإنسان يولد وهو ابن ثمانين سنة ، ويتدرج في العمر نزولا ليموت وهو ابن عشرين ، فذاك قد يكون هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من أوهام المستقبل حيث أنه يستطيع آنذاك أن يتعامل مع شؤونة بخبرة ابن الثمانين ، وإذا كان هذا عبارة عن أمنية لن تحقق ، لماذا لا نجلس إلى ابن الثمانين لنسأله عن الأشياء التي طاردها من نحو الثروة والمتعة والجاه والشهرة واكتشاف البلاد وما شاكل ذالك !! وكيف كانت مشاعره حين ظفر بها وقبض عليها ، إن هذا خير لنا من أن نسير في طريق صعبة ووعرة ستين أو سبعين سنة لنجد أمامنا لوحة تقول " عفواً الطريق مغلق " ولماذا نذهب بعيدا بعيدا والذي خلق الملذات والمسرات ورتب الأسباب والمسببات يقول في محكم كتابه : ( فمن زحزح عن النار وأدخل والجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) متاع غرور ، يغر الإنسان بكل متاع يناله من الدنيا ، ثم يتبن له أن ذالك الاغترار كان اغترارا ، وذالك الإعجاب كان اغترارا ولم يكن في محله ، ،،،
إذا كان هذا هو واقع الحال ، فلأولى بنا بدل أن نسعى إلى أشياء محددة نظن أن السعادة كامنة فيها الأولى بنا حين إذٍ أن نتبع في سلوكنا قواعد محددة ـ وأحب أن أشدد على هذه الفكرة ـ نتبع قواعد محددة في حياتنا نعتقد أن في التزامها احتمالاً كبيرا بأن نكون سعداء ، لا نسعى إلى السعادة لنصل إليها بعد خمسين سنة أو ثلاثين أو عشرين أو عشر سنوات ، لا ، من هذه اللحظة الأمور التي نعتقد أنها تجلب لنا السعادة نلتزم بها .. القواعد التي نعتقد أنها ستجلب لنا السعادة نلتزم بها من هذه اللحظة ، ونتعامل مع هذه القواعد بثقة ، كما لو أنها كانت أهدافاً في حد ذاتها ، بدل أن تجعل السعادة هدفاً اجعل التزامك بالقاعدة التي تؤدي إلى السعادة ، كأن ذالك الالتزام عبارة عن هدف في حد ذاته .........
*الملاحظة الثانية من الملاحظتين التي ذكرت أنني سأسوقهما ...
هذه الملاحظة تفيد أنه ليس هناك شيء كائناً ما كان يشكل بكل تفاصيله وبكل معطياته على وجه الانفراد حياتنا الطيبة وذالك لأن السعادة عبارة عن نشيج معقد وما يسهم في تحقيقها متعدد الأنماط والأشكال ، يعني مثلاً قد تكون في أحسن حال وتتذكر حدثاً مؤلماً فيعكرك ذالك التذكر وتلك الذكرى يوماً كاملا وقد يملك أحد الناس كل مقومات السعادة الشخصية لكنه يرزق بولد منحرف أو معوق ينكد عليه حياته وينسيه كل ألوان النعم التي يتمتع بها .. إذاً ليس وجود الأولاد وحده مهما كان يشكل نسيج سعادتنا ولا وجود المال ولا وجود المرأة المطيعة التقية الحسناء ولا وجود الجاه الجيد ولا وجود المنصب الكبير كل شيء من هذا لا يشكل بمفرده هيكل السعادة أو جسم السعادة الذي نسعى إليه ، و لو أننا سمحنا لأنفسنا أن توقف قليلاً لنقرأ أهداف الحركة اليومية الدائبة لمعظم الناس فإننا سنجد الأكثرية من العناصر النشطة في المجتمع الأكثرية من هذه العناصر النشطة وقعت في وهم هذا الوهم هو أنها تستطيع أن تغير مجرى حياتها من خلال الوصول إلى شيء ما ، فهذا يعتقد أن مبلغاً كبيرا من المال سوف يجعله في القمة ، ولما لا والمال محور الحياة كما يقولون : الذي ليس معه فلس لا يساوي فلسا ، والذي معه مليون يساوي مليون ، وهذا يعتقد أن وصوله إلى منصب معين أو إلى نفوذ قوي في مجال من المجالات سيفتح أمامه كل أبواب المجد ، وثالث يعتقد أن عليه أن يبني اسماً في مجال عمله وإذا توصل إلى ذالك لم يحول بينه وبين الفوز المعنوي و المادي أي شيء ، ورابع يعتقد أن أبناء هذا الزمان لا يحترمون إلا الشخص الناجح والمتفوق ولذا فإن النجاح بالنسبة إليه يشكل الباب العريض الذي سيدخل منه إلى عالم الأحلام الوردية ، وهكذا ...
ومع أنني أعتقد أن من الصعب جداً أن نقنع الناس بأن هذا الذي يعلقون عليه كل آمالهم في تحقيق السعادة لا يعدوا من أن يكون واحداً من الأوهام الكبيرة التي دوختنا ودوخت الأمم من قبلنا ، مع أنني أعتقد هذا إلا أن علينا أن نحاول في ذالك لعله يتشكل وعي مستقبل بهذه القضايا فيرتاح بعض المجهدين ويتأنى بعض اللاهثين ، بعض المندفعين ،،،،
إذا وقفنا تجاه المال والثروة و دورهما في تحقيق السعادة فإننا سنجد أن بني البشر جميعا في حاجة إلى المال حتى تستقيم حياتهم ويتمكنوا من قضاء حوائجهم ، إن قدراً ملائماً منه يعد شرطاً لشعور الإنسان بالطمأنينة لقيامه بالحفاظ على وجوده المادي و المعنوي ، ولكنه ليس الشرط الوحيد فشروط الحياة الطيبة عديدة والمال واحدٌ منها ، المال وسيلة ويساهم في سعادة الناس ما دام يمكن استخدامه من قبل الذين يملكونه ، فإذا فاض عن الحاجة والقدرة على الاستفادة منه فإن علاقة صاحبه به تصبح وهمية ، وأرجوا أن نضع خطاً تحت هذا ، حين يفيض المال عن الحاجة ، ويصبح عبارة عن أرقام تدخل في حساباته وتخرج منها ولا يدري أحياناً في اليوم ما ذا دخل وما ذا خرج ، حينئذٍ علاقة الإنسان بثروته تصبح علاقة وهمية ، علاقة رقمية ،،،
ومما يذكر على سبيل الرمز والعبرة أن رجلا أخبر أن له دعوتين مجابتين ، فدعا الله تعالى أن يجعل كل شيء تمسه يده ذهبا ، فأعطاه الله تعالى ما سأل ، فكاد عقله يطير من الفرح ، ليس هذا شيئاً قليلا بل شيء كبير ، وانطلق الرجل يلمس بشرهة وبنهم كل ما يجد أمامه فيتحول هذا الملموس إلى ذهب ، حتى إذا جاع صاحبنا أخذا الصحن الذي فيه طعامه فصار كل ما فيه من طعامٍ ذهبا ، وعطش فحمل الكأس ليشرب ، فصار ما في الكأس من ماء أيضاً ذهبا ، لا ماء ولا طعام ، فقعد الرجل جائعاً عطشان ، فأقبلت ابنته تواسيه على هذه المصيبة أن ما بين يديه كله صار ذهبا ، عانق ابنته وهي تواسيه فصارت أشبه بتمثال من ذهب ، وهنا لجأ الرجل بعد أن أصابه ما أصابه إلى الدعوة الثانية ، فما ذا كانت ، دعا الرجل ربه أن يعيد كل شيء كما كان ، لأنه أدرك أن الرغيف للجائع وأن الكأس للعطشان وأن البنت للأب خيرٌ من ملأ الأرض ذهبا ، فالمال الذي بين أيدينا قد يكون وسيلة لتحريرنا من الشعور بالعوز ، ومن ذل الحاجة إلى الناس ، لكن عندما ننهمك في جمع المال أملاً في حياة أهنأ وأرغد ، فإن ذالك المال قد يكون طريقاً إلى العبودية والاسترقاق ، فيهدر المرء كرامته في سبيل الحصول على المزيد منه ، وقد يقترن اكتسابه بالمعاصي من ربا ومن غش والنهب والسلب وأكل الحقوق ، لأن الملاحظ أن من يؤمن بأن المال هو كل شيء يفعل أي شيء من أجل الحصول عليه ،،،،،،،
طرحت إحدى الصحف الإنجليزية على قراءها سؤالاً هو : ما المال ؟
فكان الجواب الذي نال الجائزة هو الجواب الذي عرف المال بأنه جواز سفر عالمي يمكن لصاحبه أن يسافر إلى كل البلاد ما عدا السماء ، وهو يجلب كل شيء ما عدا السعادة ،،،،،
ونحن لسنا مع هذه المبالغة ، فالمال إذا اكتسب من حلال وأنفق في مراضي الله تعالى فإنه يدني صاحبه من الجنة ونعيمها ، وهو إن كان لا يجلب بالضرورة السعادة إلا أن المرء لا يشعر بالسعادة من غير وجود شيء كافٍ أو شبه كافٍ ، لكن أحب أن أأكد أن رجلاً بلا مال هو رجل فقير ، ولكن الأفقر منه إذا أردنا أن نغوص نحو الأعماق الأفقر منه رجل ليس لديه إلا المال ، ليس لديه خلق ، ليس لديه استقامة ، ليس لديه رحمة ، ليس لديه إحسان ، هو فقط يملك المال ، هذا هو أفقر الفقراء .................
انتهى الشريط الاول
يتبع
اتمنى ان تتابعوا الموضوع
اتمنى ان تتابعوا الموضوع
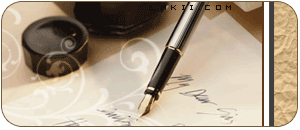

تعليق