

هي تطهير للنفوس والأموال..
وهي طهارة للمجتمع من مشاكل الفقر واكتناز الثروات، وفشو الطبقية..
وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء..
وكثير من المشكلات الاقتصادية التي يقضى عليها بهذه الشعيرة العظيمة
التي فرضها الله تعالى حقا للفقراء في أموال الأغنياء
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) [التوبة:103]
(وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ الله وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ) [الرُّوم:39]
هي
:
:
الركن الثالث من أركان الإسلام...
:
:

الزكاة
لغة هي:
البركة والطهارة والنماء والصلاح. وسميت الزكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه, وتقيه الآفات, كما قال ابن تيمية: نفس المتصدق تزكو, وماله يزكو, يَطْهُر ويزيد في المعنى..
والزكاة شرعا هي :
حصة مقدرة من المال فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم, أو هي مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة, ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى. والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة كما قال تعالى:
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم) (التوبة 103)
وفي الحديث الصحيح قال صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن:
(أعْلِمْهُم أن اللّه افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.) أخرجه الجماعة.:::

حكم الزكاة:
هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة, وعمود من أعمدة الدين التي لا يقوم إلا بها, يُقاتَلُ مانعها, ويكفر جاحدها, فرضت في العام الثاني من الهجرة, ولقد وردت في كتاب الله عز وجل في مواطن مختلفة منها قوله تعالى:
(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) (البقرة 43)
وقوله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) (المعارج 24/25).
::

حكمة مشروعيتها ..
أنها تُصلح أحوال المجتمع ماديًا ومعنويًا فيصبح جسدًا واحدًا, وتطهر النفوس من الشح والبخل, وهي صمام أمان في النظام الاقتصادي الإسلامي ومدعاة لاستقراره واستمراره,
وهي عبادة مالية, وهي أيضا سبب لنيل رحمة الله تعالى,
قال تعالى: (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة) (الأعراف 165),
وشرط لاستحقاق نصره سبحانه, قال تعالى:
(ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز, الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة) (الحج 40, 41)
وشرط لأخوة الدين,
قال تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) (التوبة 11),
وهي صفة من صفات المجتمع المؤمن, قال تعالى:
(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) (التوبة 71)
وهي من صفات عُمّار بيوت الله, قال تعالى:
(إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله) (التوبة 18)
وصفة من صفات المؤمنين الذين يرثون الفردوس, قال تعالى: (والذين هم للزكاة فاعلون) (المؤمنون 4).
مكانة الزكاة
وبينت السنة مكانة الزكاة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, وأنّ محمدًا رسول الله, ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.) أخرجه البخاري ومسلم,
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال:
(بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, والنصح لكل مسلم.) أخرجه البخاري ومسلم,
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله, وأن محمدًا رسول الله , وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا, وصوم رمضان.)
أخرجه البخاري ومسلم.
:: 

حكم منع الزكاة والترهيب من منعها :
من أنكر وجوب الزكاة خرج عن الإسلام ويستتاب, فإن لم يتب قتل كفرا, إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام, فإنه يعذر لجهله بأحكامه ويبين له حكم الزكاة حتى يلتزمه, أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام, وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها .
ودليل ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال:
لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان أبو بكر, وكفر من كفر من العرب, فقال عمر: (كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, فإن الزكاة حق المال, والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار, فأُحْميَ عليها في نار جهنم, فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره, كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقْضَى بين العباد, فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.) رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار, فأُحْميَ عليها في نار جهنم, فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره, كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقْضَى بين العباد, فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.) رواه مسلم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مُثِّلَ له يوم القيامة شُجاعا أَقْرع حتى يُطَوّقَ به عنقه.) ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) (آل عمران 180), حديث صحيح, رواه النسائي وابن خزيمة وابن ماجة واللفظ له.
(ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مُثِّلَ له يوم القيامة شُجاعا أَقْرع حتى يُطَوّقَ به عنقه.) ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) (آل عمران 180), حديث صحيح, رواه النسائي وابن خزيمة وابن ماجة واللفظ له.
وعن علي رضي الله عنه قال:
(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا وموكلَه, وشاهدَه, وكاتبَه, والواشمةَ, والمستوشمةَ, ومانع الصدقة, والمُحَلِّلَ, والمُحَلَّلَ له.) حديث حسن رواه أحمد والنسائي.

شروط الزكاة
الشرط الأول: الإسلام:
الزكاة لا تجب إلا على المسلم، أما غير المسلم فلا زكاة عليه، لكنه يحاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح.
الشرط الثاني : الحرية:
لا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئاً. والمكاتب ملكه ضعيف، لأن من شروط الزكاة الملك التام. ثم إن العبد وما ملك مُلكٌ لسيده، والسيد يزكي أمواله.
الشرط الثالث : النية:
يشترط لصحة أداء الزكاة إلى مستحقيها نية المزكي بقلبه أن هذا المال المعطى لمستحقيه هو الزكاة المفروضة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه.
والزكاة عبادة لابد أن تكون مقرونة بالنية.
الشرط الرابع : الملك التام للمال:
والمراد بالملكية التامة هنا: أن يكون المال بيد الفرد، ولا يتعلق به حق لغيره من البشر، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له.
وبهذا الشرط تخرج أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق الملك التام فيها، من ذلك ما يأتي:
1. المال الذي ليس له مالك معين، وذلك كأموال الدولة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها، لأنها ملك جميع الأمة، ومنها الفقراء.
:
2. الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو المدارس،
أو غير ذلك من أبواب الخير، فالصحيح أنه لا زكاة فيها.
:
3. المال الحرام وذلك مثل:
المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الغصب والسرقة أو التزوير والرشوة والاحتكار والربا والغش ونحوها من طرق أخذ المال بالباطل،
إذ يجب على آخذه أن يعيده إلى أربابه أو إلى ورثتهم،
فإن لم يعلمهم فيعطيه الفقراء برمته، ولا يأخذ منه شيئاً،
ويستغفر ويتوب إلى الله، فإن أصر وبقي في ملكيته وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
الشرط الخامس : نماء المال:
المقصود بالنماء هنا: أن يكون المال من شأنه أن يدر على صاحبه ربحاً وفائدة، أو يكون المال نفسه نامياً.
وعلى هذا قسم علماء الشريعة المال النامي إلى قسمين:
1. نماء حقيقي: كزيادة المال ونمائه بالتجارة أو التوالد كتوالد الغنم والإبل.
2. نماء تقديري: كقابلية المال للزيادة فيما لو وضع في مشاريع تجارية، كالنقد والعقار، وسائر عروض التجارة.
وبناء على ذلك فقد قرر الفقهاء رحمهم الله أن العلة في إيجاب الزكاة في الأموال هي نماؤها في الواقع،
أو إمكانية نموها في المستقبل لو استثمرت.
وعليه فلا تجب الزكاة في الأموال التي ادخرت للحاجات الأصلية كالطعام المدخر، وأدوات الحرفة وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه وما ينفق منه، ودواب الركوب، ودور السكنى، وأثاث المساكن،
وغير ذلك من الحاجات الأصلية، وكذا الحلي المستعمل.
والأحوط إخراج الزكاة فيه خروجاً من الخلاف لمن يقدر على ذلك.
الشرط السادس : بلوغ المال نصاباً:
اشترط الإسلام في المال النامي الذي تجب فيه الزكاة أن يبلغ نصاباً، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد النصاب، وإعفاء ما دونه من الزكاة.
الشرط السابع : حولان الحول على المال:
وذلك بأن يمر على المال في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً،
وهذا الشرط خاص بالأنعام والنقود والسلع التجارية،
أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها الحول.
الشرط الثامن: أن يكون المال فاضلاً عن حوائجه الأصلية:
لأن المال الفاضل عن الحوائج الأصلية يتحقق به الغنى،
أما المال المحتاج إليه حاجة أصلية فلا يكون صاحبه غنياً به،
وبالتالي لو ألزمه الشرع بأدائه لغيره لما طابت بذلك نفسه،
ولما تحقق الهدف السامي الذي ينشده الإسلام من وجوب الزكاة على الأغنياء ودفعها للفقراء،
وقد فسر الفقهاء رحمهم الله الحاجة الأصلية تفسيراً علمياً دقيقاً فقالوا هي:
ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد،
أو تقديراً كالدين. فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهله.
:: 


 [التَّوْبَة: 60] .
[التَّوْبَة: 60] . 
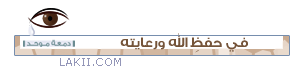
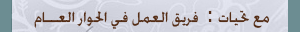






تعليق